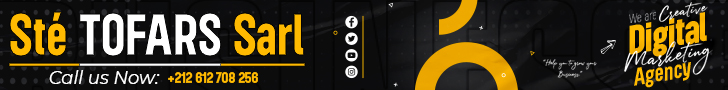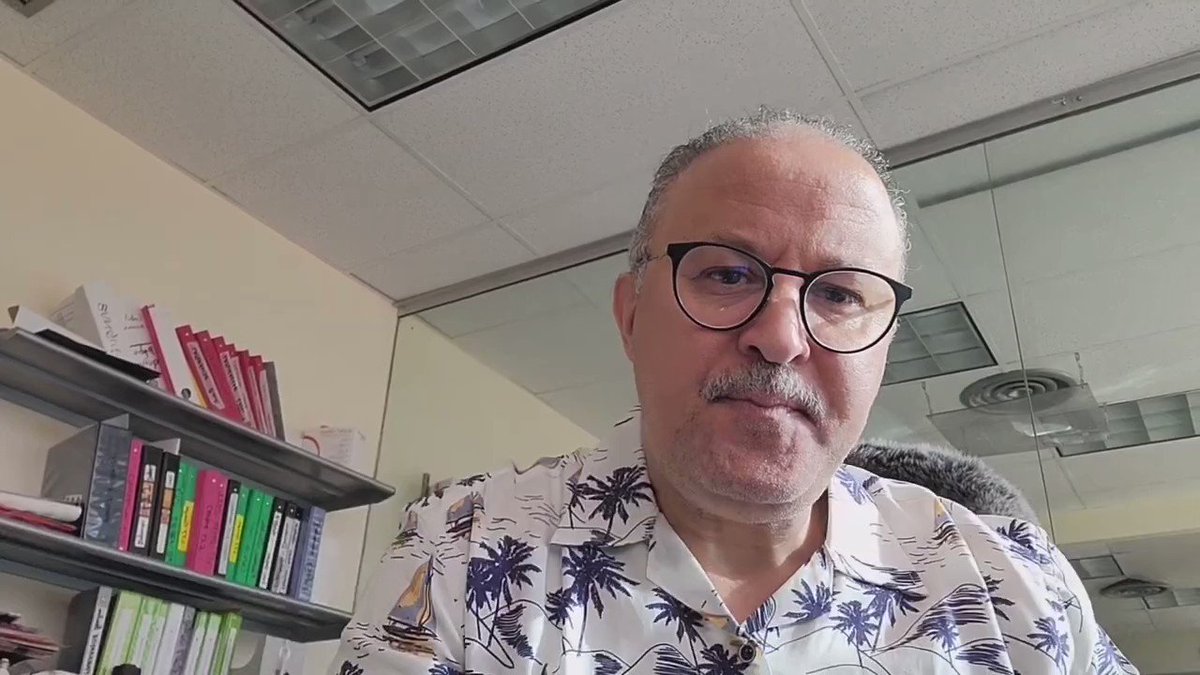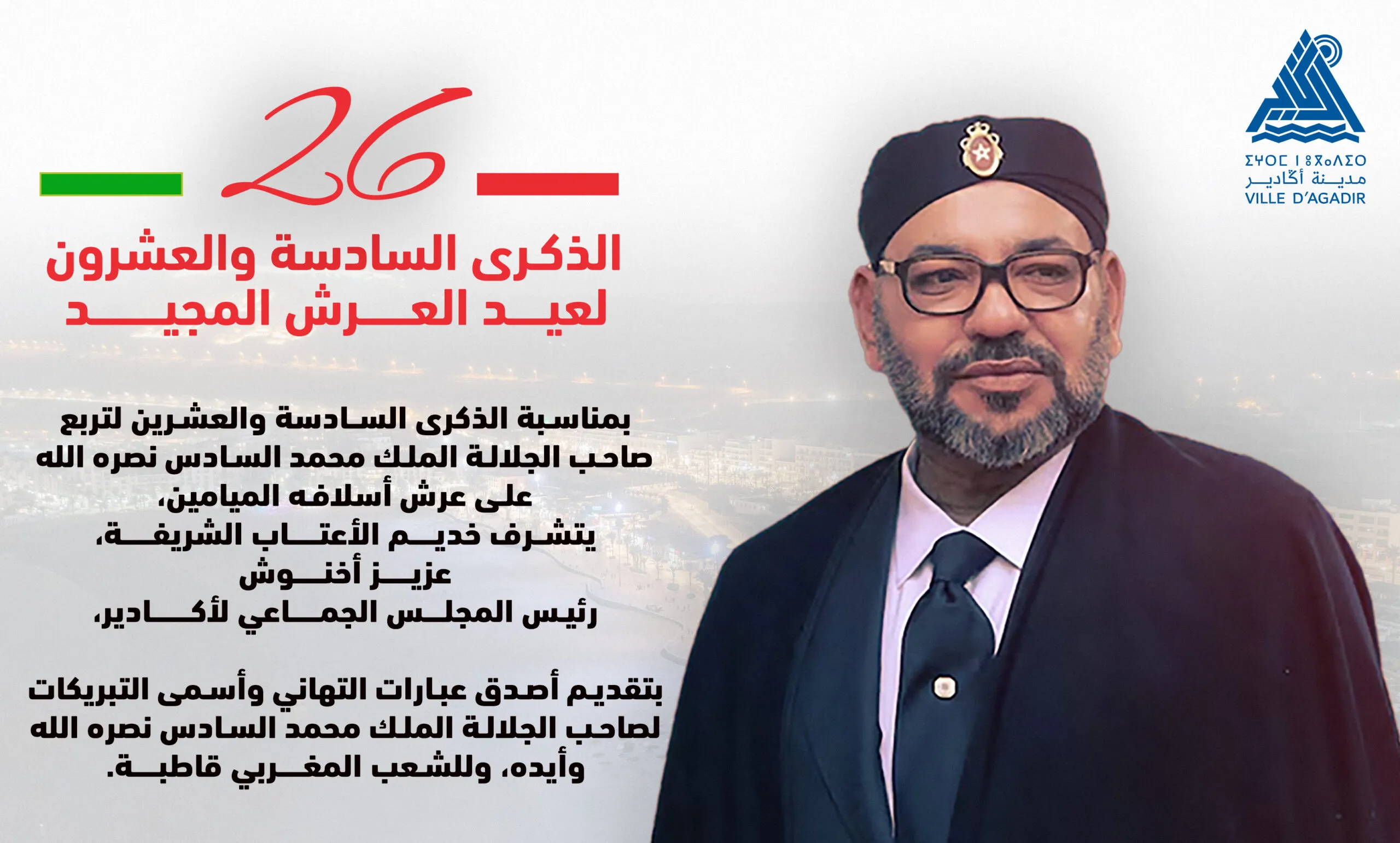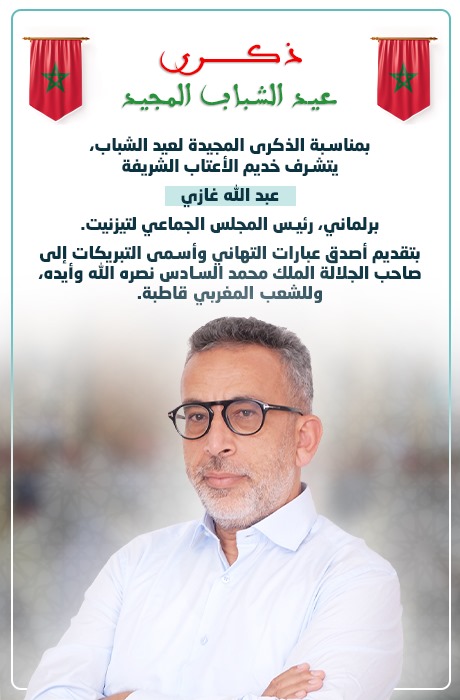يونس سركوح،
يعد موضوع التأثير الرقمي من أخطر الظواهر التي يشهدها المجال العام في عصرنا الراهن، حيث انتقلت السلطة من يد المؤسسات التقليدية إلى منصات لا مركزية مفتوحة، أنتجت فاعلين جددا فرضوا أنفسهم في صناعة الرأي وتوجيهه، بل أحيانًا في تشكيل الوقائع ذاتها عبر إعادة تعريف الأخبار وتوجيه السرديات. وفي قلب هذا المشهد، تبرز نماذج من أشخاص استطاعوا بحكم المهارة الاتصالية أو الاستغلال الذكي لمنطق الخوارزميات أن يتحولوا إلى أصوات طاغية، تتجاوز في تأثيرها أحيانًا ما تقوم به المنابر الإعلامية العريقة. وهنا تندرج حالة المدعو هشام جيراندو، الذي أصبح يمثل نموذجًا مثيرًا للدراسة في سياق تفكيك ديناميات الأخبار الزائفة والدعاية الموجهة والأجندات العابرة للحدود، خاصة حينما يتعلق الأمر بالإساءة إلى الوطن ومؤسساته ورجالاته.
إن المتأمل في مسيرة جيراندو منذ بروزه على الفضاء الرقمي، يلحظ أنه لم يتدرج من مدرسة مهنية أو من تجربة ميدانية في العمل الصحافي الرصين، بل اعتمد منذ البداية على خطاب انفعالي، يتعمد فيه الإثارة والصدمة لكسب نسب مشاهدة مرتفعة. وهذا ما تؤكده مجمل المضامين التي يقدمها عبر مقاطع الفيديو التي يغلب عليها طابع الانفعال، وكثرة الاتهامات والعبارات القدحية التي يطلقها دون سند توثيقي محكم. ولعل هذا ما دفع العديد من المتخصصين في تحليل الخطاب الرقمي إلى تصنيفه ضمن خانة ما يسمى «الصحافة الصفراء الرقمية»، التي تقوم على مبدأ إشباع الفضول السلبي للجمهور، حتى لو اقتضى الأمر تلفيق وقائع أو اجتزاء أحداث من سياقها العام.
ومن الزاوية النظرية، فإن تحليل حالة جيراندو يقتضي العودة إلى الدراسات الأكاديمية حول ظاهرة الأخبار الزائفة والدعاية السيبرانية. إذ يُجمع الباحثون في علوم الاتصال السياسي والدراسات الأمنية السيبرانية على أن الأخبار الزائفة لا تُعد مجرد أخطاء عرضية في التغطية أو نقل المعلومة، بل هي منظومة مقصودة وممنهجة في كثير من الأحيان، ذات أهداف تتراوح بين التأثير في السلوك الانتخابي للناخبين، وإضعاف الثقة في المؤسسات، وبث روح الشك والتوجس في جسد المجتمع، وهو ما يندرج ضمن مفهوم «حروب الجيل الرابع» و«الحروب الهجينة»، حيث يصبح الإعلام الرقمي سلاحًا موازيا، يُحدث آثارًا مدمرة في الشرعية الداخلية للدول.
هشام جيراندو لم يتوقف عند حدود إثارة القضايا الاجتماعية بأسلوب شعبوي، بل تطورت خطاباته بشكل لافت خلال السنوات الأخيرة لتصبح أشبه بمنصة دعائية منظمة، تركز على ضرب صورة المغرب في الداخل والخارج، وتشويه مشاريع التنمية التي يطلقها الملك والحكومة والمؤسسات الترابية، إضافة إلى تحقير الكفاءات المغربية التي تبذل جهدًا كبيرًا في مختلف القطاعات. ومما يعزز هذا الاستنتاج أن المحتوى الذي ينتجه غالبًا ما يتقاطع مع نفس النقاط التي تشتغل عليها المنصات الإعلامية الجزائرية المعادية للمغرب، بل وفي أحيان كثيرة يُعاد بث مقاطع من كلامه في نشرات وبرامج جزائرية موجهة، وكأنه يقدم لها مادة جاهزة لمواصلة التحامل على المغرب.
إن هذا التشابه اللافت في الأجندات بين خطاب جيراندو وما تبثه وسائل الدعاية الجزائرية يثير تساؤلات جدية حول طبيعة الروابط المحتملة، خاصة في ظل التقارير الدولية التي كشفت عن حجم الإنفاق الجزائري على الحملات الرقمية المضادة للمغرب. وقد أظهرت دراسات متخصصة في تتبع الأنشطة السيبرانية الموجهة كيف أن الجزائر رصدت ميزانيات ضخمة لتمويل محتويات تهدف إلى تشويه صورة المغرب في ملفات حساسة، كملف الصحراء المغربية، وملف الهجرة والأمن، بل حتى في القضايا الاجتماعية الدقيقة. من هنا، يصبح التساؤل عن إمكانية تلقي بعض المؤثرين المغاربة المقيمين بالخارج، ومنهم جيراندو، دعما ماليا مباشرا أو غير مباشر، أمرًا مشروعًا علميًا، يحتاج إلى تقنيات التتبع الجنائي الرقمي أكثر من مجرد التخمين.
وإذا انتقلنا من التحليل الاتصالي إلى المقاربة السوسيولوجية، نجد أن خطاب جيراندو يقوم على الاستثمار في مشاعر السخط الاجتماعي التي قد توجد في أي مجتمع يعاني من تحديات اقتصادية أو تفاوتات اجتماعية. فهو يركز بصورة ممنهجة على إبراز كل اختلال أو حادثة فردية وإعطائها طابعًا تعميميًا يوحي بانهيار شامل، دون الإشارة إلى أي منجزات أو تقدم تحقق في المقابل. وهذه التقنية الخطابية معروفة في علم الاجتماع السياسي بـ«تضخيم السخط» الذي يؤدي إلى إنتاج حالة نفسية جماعية من الإحباط واليأس، ما يضعف الثقة في المستقبل ويقلل من الحصانة الاجتماعية ضد الاختراقات الدعائية. ولعل هذه الإستراتيجية هي نفسها التي اعتمدتها أجهزة الدعاية في العديد من البلدان التي خضعت لحملات التشويه قبيل زعزعة استقرارها.
أما من حيث الأخلاق المهنية، فإن الرجل يفتقر إلى أبسط قواعد العمل الصحافي الرصين، الذي يقوم على ضرورة التثبت من الأخبار والالتزام بقاعدة التوازن، وإعطاء حق الرد للجهات التي يهاجمها. بل إن خطاباته لا تتردد في توجيه اتهامات خطيرة للمسؤولين والمؤسسات دون أن يقدم مستندًا قضائيًا أو وثيقة إدارية ذات مصداقية. وهذا ما يجعل ممارساته أقرب إلى نمط «الخطاب التحريضي» الذي يحذّر منه فقه القانون الإعلامي، لأنه يقوض أسس المحاكمة العادلة ويشوه سمعة الأشخاص والدولة على حد سواء، مما قد يعرض الأبرياء لأضرار اجتماعية ومهنية جسيمة، فضلًا عن تهديد السلم الأهلي.
وفي مستوى أعمق، فإن تحليل حالة جيراندو يندرج ضمن الإشكالية الأوسع التي تواجهها الدول في سياق العولمة الرقمية، وهي إشكالية الحدود المنفلشة للفضاء السيبراني. ذلك أن هذا الفضاء يتجاوز السيادات التقليدية، ويمنح لأفراد يقيمون خارج الوطن القدرة على التأثير في الداخل، دون أن يخضعوا للقوانين الوطنية أو للضوابط المهنية التي تلزم بها الهيئات الصحافية والإعلامية. وهو ما يطرح تحديات حقيقية أمام المشرعين والقضاء، حيث يصبح من الصعب ملاحقة مثل هؤلاء وفق القوانين الجنائية الوطنية، ما لم يتم تطوير آليات للتعاون القضائي الدولي في جرائم التشهير ونشر الأخبار الزائفة.
من ناحية ثانية، تكشف حالة جيراندو عن قصور في التربية الإعلامية لدى جزء من الجمهور الذي يستهلك هذا النوع من المحتوى دون تمحيص أو مطالبة بالدلائل. فالبيئة الرقمية الحالية قائمة على الإعجاب السريع والمشاركة اللحظية، مما يعزز تداول الأخبار المضللة دون تحقق. ومن هنا تبرز المسؤولية المضاعفة للمؤسسات التربوية ومنظمات المجتمع المدني في إشاعة ثقافة التحقق، وتعليم الأجيال الجديدة مهارات التفكير النقدي التي تمكنهم من التمييز بين الحقيقة والدعاية. فالدول القوية ليست فقط التي تتوفر على جيوش وأجهزة أمنية فعالة، بل تلك التي يمتلك مواطنوها وعيًا نقديًا يجعلهم محصنين ضد الخدع الاتصالية.
ومع أن حرية التعبير تعتبر حجر زاوية في كل المجتمعات الديمقراطية، فإنها لا يمكن أن تتحول إلى حصانة للخطاب المضلل أو المنصات التي تتحول إلى بوق لأجهزة أجنبية تسعى للنيل من الوحدة الوطنية. فحتى في أعرق الديمقراطيات، هناك قوانين صارمة تجرم نشر الأخبار الكاذبة التي تمس بالأمن القومي أو بالأشخاص، مثلما هو الحال في التشريعات الأوروبية التي تشترط على المنصات الرقمية التعاون في حذف المحتويات المضللة، وفي القوانين الأمريكية التي تسمح بملاحقة من ينشرون معلومات زائفة تضر بالمصالح العليا للدولة. وهكذا فإن الدعوة إلى مساءلة جيراندو وغيره من صناع المحتوى الذين يتجاوزون الخطوط الحمراء ليست قمعًا لحرية الرأي، بل هي حماية للحق في إعلام نزيه وللوطن من حملات التشويه.
جدير بالذكر أيضًا أن خطاب جيراندو لا يكتفي بالإساءة إلى مؤسسات الدولة، بل يتعداه إلى محاولة تشويه صورة العديد من الشخصيات الوطنية التي خدمت المغرب بصدق وإخلاص. فالرجل يوظف أسلوب التعميم والتلويح بالاتهامات الأخلاقية دون دليل، ما يُعد في علم المنطق مغالطة معروفة باسم «مغالطة السمعة»، إذ يلجأ إلى ضرب مصداقية الأشخاص عوض مناقشة الأفكار أو السياسات بموضوعية. وهذه التقنية شائعة في الخطابات الشعبوية التي تعجز عن تقديم بدائل عملية، فتكتفي بالتهجم الشخصي لإلهاء الجمهور عن مناقشة الجوهر.
إن هذه القراءة التحليلية لحالة هشام جيراندو ليست موجهة للتقليل من حقه في التعبير، ولا في نقد السياسات العمومية متى كان ذلك قائما على معطيات دقيقة وحجج سليمة، بل هي دعوة إلى وضع الظاهرة في سياقها الأكاديمي الذي يميز بين النقد البنّاء الذي يهدف إلى الإصلاح، والخطاب الشعبوي المضلل الذي يختفي خلف شعارات براقة ليمرر أجندات لا تخدم سوى خصوم الوطن. وهو تمييز جوهري بات أكثر إلحاحًا في عصر الإعلام الرقمي، حيث لم تعد الحدود الفاصلة بين الناشط والصحافي والمخبر الدعائي واضحة، مما يفرض مسؤولية جماعية لحماية الوعي الوطني.
وفي ختام هذا التحليل، يمكن القول إن مواجهة مثل هذه الظواهر لا ينبغي أن تقتصر على الجانب الأمني أو القضائي فحسب، بل يجب أن تُقارب بمنهج شمولي يدمج التربية الإعلامية، ودعم الصحافة الجادة، وتحفيز البحث العلمي في مجال الاتصال والدعاية السيبرانية، إضافة إلى تعزيز ثقة المواطن في مؤسساته عبر سياسات تواصلية أكثر شفافية وانفتاحًا. ذلك أن الفضاء الرقمي بات ساحة معركة حقيقية تتنافس فيها الحقائق والأكاذيب، والحصانة الحقيقية للمجتمعات هي وعيها النقدي وقدرتها على فرز الغث من السمين.
وهكذا، فإن هشام جيراندو يمثل في النهاية أكثر من مجرد حالة فردية، إنه عرض من أعراض مرحلة انتقالية يعيشها الفضاء العمومي المغربي، تتطلب منا جميعًا مزيدًا من اليقظة الفكرية والجرأة على مساءلة مصادر معلوماتنا، حتى لا نتحول إلى مجرد مستهلكين عاطفيين في لعبة كبرى تديرها أحيانا عقول وأموال خارجية، لا هدف لها سوى زعزعة استقرار الأوطان وتقويض تماسكها الداخلي.